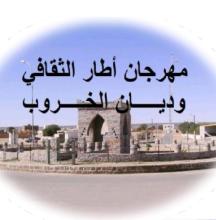الوزير السابق أحمد سيدي بابا يكتب: خواطر حول جذور الداء وآفاق الشفاء

قُبَيْلَ استقلال بلداننا، سادَ العالمَ، شمالا وجنوبا، سرابُ الرؤى والنظريات التي جاء بها الفكر الماركسي المهيمن آنذاك في الاتحاد السوفيتي وفي الفضاء الخاضع لنفوذه. وقد انتشرت كذلك هذه الرؤى والنظريات على نطاق واسع حتى شملت البلدان الأوروبية ذات الاقتصاد الليبرالي نفسها، بفعل مفكرين ونشطاء من مختلف المدارس ذات المشارب الاشتراكية.
وقد وجدت هذه الأوهام المغرية أو "اليوتوبيا السخية" آذانا صاغية في معظم بلداننا الإفريقية التي كانت آنذاك تشهد تشكل الحركات الساعية للتحرر من أغلال الاستعمار. وقد ساهم الدعم السياسي الذي كان يقدمه دعاة هذه الأفكار، وكذلك دعمهم المادي، في استمالة هذه الحركات الإنعتاقية واعتناقها لذلك الفكر اليساري لدرجة أن هدف القضاء على الاستعمار صار مرتبطا ارتباطا عضويا بإقامة أنظمة اقتصادية من النوع الاشتراكي مما ولد، دون عناء علمي أو منهجي) إذ أنه لم يكن مقيداً بأي احتساب لفطرة البشر ولا حتى اكتراث بإكراهات الواقع ناهيك عن أي اعتبارات روحانية أو دينية ، خليطا مغرياً وسهل التسويق يجمع في نضال واحد أهداف التحرر وتطلعات التنمية والعدالة الاجتماعية.
وعن هذا الفكر يقول الجنرال ديغول في إحدى مقولاته الاستشرافية: "في الحراك الدائم للعالم، لكل الإيديولوجيات ولجميع الثورات عمر محدود. كذلك فإن الشيوعية حتما ستمضي". لكن هذه المقولة لم تجد صدىً بين القادة الأفارقة حينها، إذا ما استثنينا ثلةً قليلةً على غرار محمد الخامس ملك المغرب، والرئيس الإيفواري هوفويت بوانيي، والرئيس التونسي بورقيبة، والرئيس السنغالي سنغور.
وبالفعل "مضت" الشيوعية أو زالت كعقيدة سائدة إلا أنه تولد منها ما صار يعرف لاحقاً بالإشتراكية "ذات الوجه الإنساني" أو بـ"الإشتراكية الديمقراطية" بعد ذلك.
ورغم مُضِيِّها، لم تغرب شمس الشيوعية قبل أن تشبع العقول، وخاصة عقول شباب بلداننا، بفكر الاحتجاجية المثالية ومختلف أشكال المعارضة التي لا تراعي فوارق ولا يقيدها إنصاف، مطابقة تماماً في ذلك منهجية وسلوكيات الفكر الماركسي الثوري. ومما رسخ هذا النمط، حالة العوز الشديد التي تعيشها بلداننا وما كانت توصف به – عن حق أو غير حق - الأنظمة التي تولت مقاليد الأمور في دولنا بُعَيْدَ الاستقلال من تبعية للقوى الاستعمارية السابقة وذلك ما أضفى نوعا من المصداقية على تلك الأشكال من المعارضة وفرضها كمُسَلَّمَةٍ لا تحتمل الإنتقاد وكرَّسها كنهج لا بديل له.
أمَّا في بلدنا موريتانيا، فقد تحجَّرَ هذا الخليط بإضافة شتى الحركات القومية مثل "الزنجوية" و "البعثية" و "الناصرية"، التي انتشرت في إفريقيا لما لها من جاذبية عاطفية.
وقبل المضي قدما في التحليل يجب التنبيه هنا إلى أن هذه النظريات والحركات القومية لم تكن مستنبطة بأي شكل من الأشكال، من حضارتنا الإسلامية أو ثقافاتنا التليدة بل هي بعيدة منها كل البعد، إذ أنها مستوحاة بشكل مباشر، وأحيانا غير مباشر، من حضارة وثقافة الغرب اليهودي المسيحي الذي سعى سعيا حثيثا إلى احتوائنا وإبعادنا عن فطرتنا وقيمنا، وقد حقق في ذلك نجاحات لا يمكن إنكارها، للأسف الشديد.
وهذه الفطرة في موريتانيا، على مختلف أعراقها وجهاتها وقبائلها، موروثة من الحضارة الإسلامية العظيمة ببساطتها الأولى والنقية آنذاك من جميع شوائب التشيعات، أي كما كان يعيشها أسلافنا من أيام ملاحم المرابطين وحتى ظهور حركات الجهاد التي تمثلت في حملات ناصر الدين وبعدها في إماميات فوتا تورو وفوتا جالون وغيرهم.
وهكذا فإن نخبنا في موريتانيا، وخاصة شبابنا إبان استقلال البلد، لم تجد أمامها هيكلا مرجعيا مستوحىً من قيمنا ويحيط بمتطلبات تسيير دوائر الدولة ويستطيع مواكبة نوازل السياسة والإقتصاد، أو بصيغة أخرى، بسبب عدم وجود تقليد للنقاش الجدلي الهادئ والعقلاني بين سلطة مركزية وطنية راسخة ورأي عام متمرس، وجدت هذه النخب أنفسها إذاً مجبرة، في التعاطي مع هذه الظاهرة الجديدة والمتمثلة في السلطة المركزية، على اعتماد مُسَلَّمات وسلوكيات، وكذلك انحرافات، الخليط المذكور أعلاه والذي بقيت عقولهم وأذهانهم مشبعة به.
و مع التطور الفوضوي للإنترنت تفاقم هذا التشبع إلى أن وصل حد الإفراط، وصار يؤثر على الرأي العام بجميع مكوناته: وسائل الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، كما أنه أثر على المواطن العادي، ربما المتعلم أكثر من غيره، بحيث لم يعد يقبل من الذين يحكمونه بأقل من التلبية الفورية والشاملة لجميع رؤاه المثالية وتطلعاته القصوى، واقعية كانت أم لم تكن.
وقد أدى هذا الوضع إلى تبعات في منتهى السلبية تؤثر اليوم تأثيرا عميقا على الرأي العام بجميع مكوناته وحتى على طبيعة وتصرفات الدولة نفسها.
والآن لا مناص من التوقف عند هذه التبعات وتحليلها إذ أنها، منذ 1978، عصفت بما تحقق من تقدم تحت إمرة الرئيس المختار ولد داداه، رحمه الله، خاصة فيما يتعلق بوقار دولتنا وهيبتها على المستوى الخارجي وكذلك على مستوى الانسجام الاجتماعي عن طريق الحد من الاختلافات وبالتالي الحد من الطائفية العرقية والجهوية والقبلية.
وكان هذا التقدم قد سمح للرئيس المختار، رحمه الله، بالنظر جدياً في امكانية اعتماد التعددية الحزبية كما وثق ذلك في الصفحة 326 من النسخة العربية لمذكراته والتي كتب فيها حرفيا: "ومع هذا فقد كنت اعتقد في قرارة نفسي أن الحزب الواحد الذي يعتبر حيويا وضروريا لبلادنا في تلك المرحلة من تطورها ينبغي أن يفسح المجال للتعددية الحزبية عندما يصل تدعيم الوحدة الوطنية الى مستوى يسمح بذلك. وقد ظل هذا الهاجس يلاحقني حتى انتهى بي الامر الى أن حدثت به صراحة أقدم رفاقي أحمد ولد محمد صالح يوم 8 من يوليو [أي يومين فقط قبل انقلاب 10 يوليو]. وقد اتفقنا على أن نناقش هذا الموضوع بصورة أعمق فيما بعد، لكن "وما تشاءون إلا أن يشاء الله"." انتهى الاقتباس.
لنشد هنا، بشكل عابر، بأناقة اختيار عبارة "رفاقي" بدل "وزرائي".
على مستوى الرأي العام:
قد لا يعلم الكثيرون اليوم أن الممارسة الديمقراطية، وإن لم تكن معتَمَدةً نصيا، كانت حاضرة في روحها عبر اعتماد نهج التشاور داخل الهيئات القيادية للحزب الواحد وفي مداولات الحكومة. ومع قدوم السلطات المنبثقة عن الإنقلابات العسكرية، اختفت هذه الممارسات الديمقراطية بفعل الانتشار المتزايد للنمط الاستبدادي لدى القادة الجدد. ورغم النيات الحسنة، والتي لا شك أنها كانت صادقة، التي عبر عنها هؤلاء القادة، فقد وجد المواطنون أنفسهم "مجندين" في دعم أنظمة وصلت إلى السلطة بقوة السلاح وليس بالإرادة الحرة للناخبين.
وفي هذا السياق جاء دستور يوليو1991 ليكرس التعددية السياسية التي طال انتظارها، إلا أن هذا التقدم الديمقراطي كان محكوما عليه سلفا بسبب السمة الاستبدادية للسلطات المتعاقبة ومخاوفها من احتمال فقدان السيطرة مع تجذر الثقافة الديمقراطية الحقيقية، وكانت أبرز تجليات هذا التحول هي:
- طفرة غير متوقعة في عدد الأحزاب السياسية والتي كانت في معظمها - مع بعض الاستثناءات - دون برامج سياسية حقيقية ويتسم بعضها بالطائفية أو العرقية أو الجهوية أو القبلية أو حتى أحيانا بالنفعية الفجة. وقد أدت هذه الطفرة، تحسبا لخط