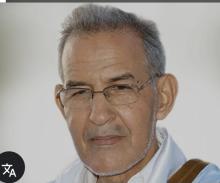اخراج زكاة الفطر بالقيمة أو بالحبوب ؟
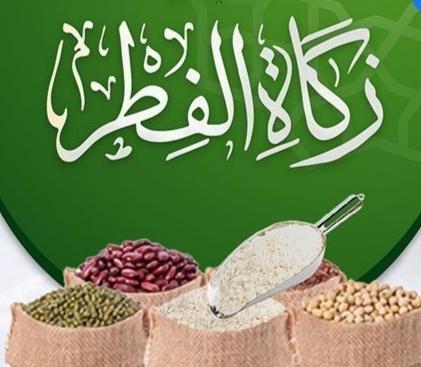
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كل حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه، وغيره من أحاديث الباب.
ومع ذلك فقد أجاز فقهاء الحنفية إخراجها مالًا؛ إذ إنها شرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير ودفع حاجته فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، وأن الأصناف المذكورة في الأحاديث ليست للحصر وإنما كانت للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جازَ عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغِنَى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحِنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحِنطة والشعير كان لأن البِيَاعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البِيَاعات تجرى بالنقود، وهي أعزّ الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 72، ط. دار الكتب العلمية): [وروي عن أبي يوسف أنه قال: الدقيق أحب إليَّ من الحنطة، والدراهم أحب إلي من الدقيق والحنطة؛ لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير] اهـ